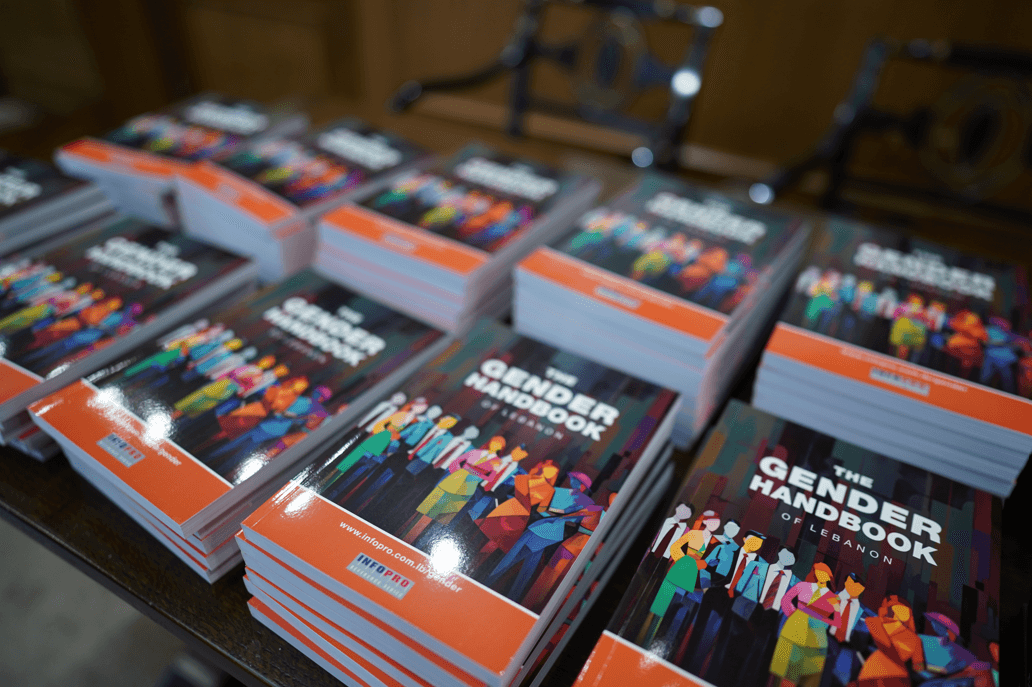
بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — في خطوة لتعزيز النقاش الوطني حول العدالة الجندرية، أُطلق رسميًا "دليل النوع الاجتماعي في لبنان" يوم الثلاثاء 17 حزيران في فندق لو غابرييل ببيروت، بحضور صنّاع سياسات وخبراء دوليين وباحثين.
ويهدف الدليل إلى دعم دمج منظور الجنسين في السياسات العامة والمبادرات التنموية والبرامج الاجتماعية. ويقدم نظرة شاملة على الفجوات بين الجنسين في لبنان، مع التركيز على ستة محاور رئيسية: سبل العيش، التعليم، الصحة، العنف المبني على النوع الاجتماعي، الإطار القانوني، ومشاركة النساء في القطاعين العام والسياسي.
في كلمته الافتتاحية، شدد الناشر رمزي الحافظ على ضرورة معالجة الفوارق بين الجنسين، مشيرًا إلى تصنيف لبنان المنخفض بشكل مثير للقلق في المؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي.
وقال الحافظ: "رغم سنوات من العمل والعديد من الدراسات، نحن بالكاد نحرز تقدمًا. لبنان عالق بالقرب من القاع — 136 من أصل 148 عالميًا. وحتى عند تحقيق تقدم، فهو غير كافٍ للحاق بالركب."
كشف الحافظ أن الدليل استند إلى أكثر من 150 دراسة موثوقة من مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية ومراكز أكاديمية.
وأضاف: "ركزنا بدقة على الحقائق والنتائج، مع تجنب التوصيات المحددة للحفاظ على الموضوعية."
وأشار إلى التحديات الأساسية في جمع البيانات، مثل الدراسات القديمة، والنتائج المتضاربة، والتغطية الوطنية المحدودة.
وأوضح الحافظ: "بعض التقارير تدّعي الشمولية لكنها مبنية فعليًا على عينات غير رسمية أو جزئية. وحتى الدراسات الصادرة عن منظمات محترمة في نفس الفترة غالبًا ما أعطت استنتاجات متضاربة."
ولضمان الاستدامة، أطلق المشروع منصة إلكترونية مصاحبة تضم المحتوى الكامل للدليل مع موارد إضافية واسعة تشمل دراسات مصنفة، إحصاءات، ودليل للمنظمات التي تعمل في قضايا النوع الاجتماعي في لبنان.
رؤى مفصلة: كشف الفجوات النوعية في لبنان
بدأت الباحثة الرئيسية للدليل جينيفر أبو مراد بالحديث عن موضوع سبل العيش، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية عمقت الفقر في لبنان، خصوصًا بين الأسر التي ترأسها نساء، والتي تواجه انعدام الأمن الغذائي بشكل أشد من الأسر التي يرأسها رجال. وتكون هذه الفجوة أكثر حدة في المناطق الريفية وبين الأسر التي لديها أطفال صغار، حيث يصل معدل الفقر في الأسر النسائية إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف مثيله لدى نظرائها الذكور.
وأبرزت أن ضعف النساء مرتبط بشكل وثيق بالتحديات في سوق العمل والأدوار الاجتماعية. رغم أن النساء يشكلن 53% من السكان في سن العمل، إلا أن مشاركتهن في القوى العاملة منخفضة جدًا عند 22%، مقارنة بـ66% للرجال. والأكثر حدة، أن نسبة النساء العاملات الفعليات لا تتجاوز 15%.
أوضحت أبو مراد أن المشاركة في القوى العاملة تبلغ ذروتها بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عامًا، لكنها تنخفض إلى النصف بعد إنجاب الأطفال، ولا تعود للارتفاع إلا بعد انتهاء الأطفال من التعليم الإلزامي. تواجه النساء الريفيات تحديات إضافية بسبب ندرة فرص العمل وغالبًا ما تُحتكر الوظائف للرجال باعتبارهم المعيلين الأساسيين بينما تُنظر النساء كمقدمات رعاية.
وأشارت إلى تركيز النساء في قطاعات خدمية نمطية مثل التعليم والصحة، مما يحد من تمكينهن الاقتصادي. رغم تفوق النساء تعليميًا على الرجال، إلا أن تمثيلهن في المناصب الإدارية ضعيف جدًا، حيث توجد امرأة واحدة فقط في منصب إداري لكل عشرة رجال. كما أن ريادة الأعمال محدودة، إذ تمتلك النساء 10% فقط من الشركات و5% منها تمتلكها النساء بأغلبية.
تظل الشمولية المالية عقبة رئيسية، ففي 2018، كانت 50% من النساء يملكن حسابات بنكية مقابل 70% من الرجال، لكن بعد الأزمة انخفضت النسبة إلى حوالي 17% فقط. يعتمد العديد من النساء على قنوات إقراض غير رسمية وغير آمنة. بالإضافة لذلك، المعرفة المالية منخفضة، إذ تُعتبر 25% فقط من النساء ملمات بالشؤون المالية مقابل 45% من الرجال.
في التعليم، أحرز لبنان تقدمًا، حيث تحقق تكافؤ تقريبي في فرص التعليم مع تفوق الفتيات أكاديميًا في كثير من الأحيان. تتفوق معدلات الالتحاق في التعليم الثانوي والعالي بين الفتيات، كما أن النساء الأصغر سنًا يعانين من نقص التعليم أقل بكثير مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا. مع ذلك، ما تزال البطالة بين الشابات مرتفعة، خصوصًا بين الفتيات اللاتي لا يعملن ولا يتعلمن أو يتدربن (NEET)، حيث تصل إلى 50% في بعض المناطق الريفية.
وأشارت أبو مراد إلى ميل المناهج التعليمية إلى توجيه الفتيات نحو تخصصات نمطية، مما يقيد مشاركتهن الاقتصادية المستقبلية.
في الصحة، أشارت إلى أن التغطية عادة ما تكون متساوية، لكن تظهر فجوات مع التقدم في العمر والحالة الاجتماعية، بحيث تواجه الأسر التي ترأسها نساء تحديات كبيرة في الحصول على الأدوية والخدمات الصحية.
لبنان حقق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمعدلات وفيات الأمهات بشكل عام، لكن التفاوتات ما زالت قائمة بين المناطق وبين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين، حيث ترتفع معدلات وفيات الأمهات لدى اللاجئات السوريات. بعد الأزمة، شهدت وفيات الأمهات بين النساء اللبنانيات زيادة نتيجة تدهور الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
وتحسنت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لكنها لا تزال غير متاحة أو تشكل وصمة للنساء غير المتزوجات.
كما تناولت أبو مراد قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، كاشفة أن 37% من النساء والفتيات في لبنان قد تم التعرض لهن جسديًا أو جنسيًا. كما لا يزال هناك تقليل في الإبلاغ بسبب الوصمة والخوف، وذلك بالرغم من صدور تشريعات حديثة تجرم التحرش الجنسي والاتجار والعنف الأسري، إلا أن ثغرات كبيرة لا تزال موجودة، منها الثغرات التي تسمح للمعتدين بالتهرب من العدالة.
التحديات القانونية والسياسية
في المجالين العام والسياسي، لا يزال التقدم بطيئًا للغاية. لبنان أغلق 3% فقط من الفجوة بين الجنسين في المشاركة السياسية، مقارنة بتكافؤ تقريبي في التعليم والصحة.
وتمثل النساء 21% فقط من القوى العاملة في القطاع العام، ومعظمهن في التعليم، مع وجود ضئيل في القوات الأمنية والسياسة. في انتخابات البرلمان 2022، كانت نسبة النساء الناجحات 6% فقط، رغم أن معدلات نجاح النساء في الانتخابات البلدية أعلى.
شددت أبو مراد على أن الأنظمة السياسية والقانونية اللبنانية تكرس التمييز، ليس فقط عبر قوانين صريحة مثل قانون الجنسية الذي يمنع النساء من نقل الجنسية لأطفالهن، بل أيضًا عبر الأعراف الاجتماعية الأبوية التي ترى النساء كمقدمات رعاية لا كقائدات.
ويشمل التمييز قوانين عمل متحيزة، فجوات في الضمان الاجتماعي، تمييزًا ضريبيًا، ونقصًا في سياسات المناهج التعليمية.
أبرز مداخلات الجلسة النقاشية
عبّرت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن دعمها القوي للدليل، واصفة إياه بأنه "مورد عام حيوي يجب أن توفره الحكومة بنفسها". وأكدت السيد أن لبنان يعاني من نقص حاد في البيانات، معتبرة إياه "البلد الأكثر فقراً للبيانات في العالم"، مما يعرقل صنع السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وأشارت إلى الطبيعة المجزأة والمتضاربة للبيانات الموجودة، مع ذكر التحديات المتعلقة بنقص الموارد وقضايا الحوكمة في الجهاز المركزي للإحصاء.
وأكدت استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية للتعاون في تحديث وتوسيع جمع بيانات النوع الاجتماعي، بما في ذلك الدفع نحو تنفيذ مسوح وطنية أساسية مثل التعداد السكاني ومسح ميزانيات الأسر مع تفصيلات حسب الجنس. وشددت السيد على ضرورة إصلاح قواعد الوصول إلى البيانات لضمان توفيرها للعامة من الباحثين وصانعي القرار، لتحويل الإحصاءات إلى أدوات للنقاش المستنير واتخاذ القرار المبني على الأدلة.
ووضعت بليرتا أليكو، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، تحديات بيانات النوع الاجتماعي في لبنان في إطار أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن 12 فقط من أصل حوالي 80 مؤشراً ذات صلة بالنوع يتم جمعها بشكل منهجي من قبل المؤسسات الوطنية. وأبرزت الفجوة بين توفر البيانات واستخدامها الفعّال في صنع السياسات.
استنادًا إلى خبرتها في دول أخرى، أكدت أليكو أن التقدم في السياسات يعتمد ليس فقط على البيانات بل على الإرادة السياسية والقدرة المؤسسية.
وأشارت إلى مشكلة توافقية البيانات — نقص المنهجيات الموحدة والتنسيق — مما يعقد جهود تفسير واستخدام بيانات النوع بشكل متناسق.
وشددت أليكو على أهمية دمج اعتبارات النوع في عمليات الميزانية الوطنية، بما في ذلك الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر في مقاييس الاقتصاد والتعويضات الاجتماعية، مما يربط بيانات النوع بنتائج سياسة ملموسة في التعليم والحماية الاجتماعية والتخطيط المالي.
وركّزت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، على أهمية ترسيخ بيانات النوع الاجتماعي ضمن النظام الإحصائي الوطني في لبنان. ودعت إلى اعتماد استراتيجية إحصائية وطنية شاملة تُعطي الأولوية لإنتاج واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس في جميع الوزارات، بما في ذلك وزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والزراعة.
وأبرزت المسيري قيمة البيانات الإدارية، مثل التعداد الزراعي، كمصدر مهم وغالبًا ما يُستهان به لبيانات النوع الاجتماعي.
ودعت أيضًا إلى بناء القدرات وتعزيز التنسيق داخل الجهاز المركزي للإحصاء، مشيدة بالمواهب الموجودة رغم التحديات، ومؤكدة على الحاجة الملحة لزيادة التمويل والدعم.
وربطت المسيري القضية بالتزامات لبنان الدولية بموجب الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أهمية التقارير النظامية والمساءلة القائمة على البيانات على المستويات الإقليمية والعالمية.
وأكد المشاركون في الجلسة النقاشية على الدور الحيوي للبيانات الموثوقة والمتاحة والمنسقة كقاعدة لسياسات فعالة وتنمية مستدامة في لبنان.
ومن المتوقع أن يُثير إطلاق الدليل حوارًا وطنيًا أوسع حول سد فجوات النوع الاجتماعي في لبنان ويخلق مرجعًا مشتركًا للتدخلات المستقبلية.



